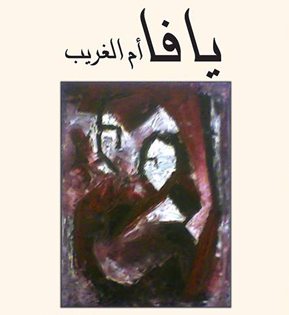

الهوية والإبداع
د. مليحة مسلماني
الحدث - كالقابضِ على الجمر، يقبض الفلسطيني على روايته ذاكرةً بصريةً وشفويةً تتفتحُ على الما لا نهائي من الاشتغال وإعادة السّردِ والرسمِ والتوثيق. وكقدرٍ يحدّدُ إشارات وتضاريسَ الطريقِ للسائرين، تتشكل الرواية الفلسطينية عبر تجربةٍ استثنائية خَبِرها الفلسطينيون؛ الحرب ثم التهجير ثم اللجوء ثم المنفى، ثم الحروب والنكسات المتعاقبة. تلك التجربة المتعطّشة دومًا لأقلام الكتّاب وأدوات الرسامين والمبدعين، لا تنفكّ تسرد ذاتها بين قطبيْن: واقع المنفى والترحال الدائم في البلاد، وقطب تدور حوله أحلام العودة. هكذا تحضر الرواية الفلسطينية موازيةً لعالم الرواية الأدبي، لا تخضع له، لكنها بذات الوقت لا تختلف عنه بامتلاكها عناصره التي لا يحدّدها خيال الروائي، وإنما الواقع الفلسطيني المرير، فشخوصها، والصراعات التي تعيشها تلك الشخوص، والسفر عبر الأمكنة والأزمان، هي عناصر الرواية الأدبية، وهي أيضًا عناصر الرواية الفلسطينية الحيّة، التي يبقى شخوصها المهجّرين والمنفيين الدائمي الترحال واللااستقرار، ومكانها يَتَبَرزَخُ بين وطنٍ أولّ حيٍّ في الذاكرة، وواقع منفىً باردٍ جاثمٍ على الصدور.
هكذا هي سطور كتاب “يافا.. أمّ الغريب”، للكاتبة أسماء ناصر أبو عيّاش، الصادر مؤخرًا عن “دار البيرق العربي للنشر والتوزيع”: سرديةٌ فلسطينية تأبى أن تتخذ أحد الصنوف الأدبية، كالرواية أو القصة، ثوبًا، وتترك لنفسها شقّ طريقٍ زمانه يبدأ منذ عام النكبة، أو منذ ما قبلها، ليواصل عبر عملية سردية تراكمية معقدة ومستمرة باستمرار حلم العودة الذي، وإن تراءى حلمًا في الخيال يصعب تحقيقه، إلا أنه خيال خصب ما زال يصر على الحضور الحيّ من خلال الإنتاج الأدبي والإبداعي المتجدد بتجدد جرح ينفتح مع كل استفزازٍ للذاكرة.
تتداخل سرديّات الكاتبة أبو عيّاش عن ذاكرتها حول يافا وتجربتها في اللجوء المستمر مع سرديات آخرين يروون بأنفسهم ذاكرتهم عن المدينة. تُعنون الكاتبة ولادة العلاقة مع يافا زمنيًا، منذ كانت طفلة تراقب ساعة ذات بندول معلّقة على أحد جدران غرفة جدتها، كانت الساعة قد حُملت في صندوق أودعَ فيه بعضًا من مقتينات بيتهم في يافا. تختزل الساعة دلالة زمكانية: لحظة بدء الحكاية وولادة ذاكرة الطفلة، والمكان الذي ما زالت الساعة الخشبية تحمل رائحته. زمكانية المأساة تظهر أيضًا في روايات الشخوص الذين بحثت عنهم الكاتبة واستنطقت ذاكرتهم، لا بِحثّهم على التذكّر، بل بتماهيها معهم، فهي نفسها تحفظ ذاكرة يافا نقلًا عن أبيها وأسرتها التي هُجّرت من المدينة، لتعلن: “خرجتُ من ثوب الراوي وأضربتُ عن مشقّةِ الاستنطاق وتركتُ ليافا أن تروي عن نفسها” (ص12).
في “يافا أم الغريب”، تتكرر السرديّة الفلسطينية التي جاءت في أعمال أدبية كثيرة لعل من أبرزها رواية “عائد إلى حيفا” لغسّان كنفاني، وأعمال أخرى لأدباء فلسطينيين تسرد تجربة التهجير والمنفى، لتأتي “يافا أمّ الغريب” تراكمًا مميزًا وبثوب جديد، أكثر واقعية وتنوّعًا، إذ تُطرح يافا هنا روايةً شفوية تحكيها شخوص عدّة خاضوا التجربة، يجمعهم أن يافا البرتقال والبحر والمباني العتيقة تتمركز في وجدانهم وفي قلوبهم وذاكرتهم. ترصد الكاتبة الصدمات التي واجهها الشخوص الذين احتفظوا بذاكرة البيت والمكان اليافيّ، فعادوا يبحثون عنه، يحملون خريطة المكان الأول التي رسمها الآباء، يتوهون في التضاريس الجديدة للمكان، بعضهم يصدمه أنه لا يجد الحيّ الذي نشأ فيه هو أو أسرته بعد أن أُزيلَ تمامًا، وبعضهم الآخر يقف على عتبات البيوت التي هجّروا منها، ينتظرون من أصحابها الذي ما زالوا في نظرهم “جددًا” إذنًا بالدخول. الصدمة المرصودة في “يافا أمّ الغريب” ليست كالصدمات التي شفاؤها الوقت، بل هي صدمة الفلسطيني التي تقف عند عام 1948، لا يتحرك التاريخ منذ ذلك الحين ولا يسكن الألم ولا تهدأ الذاكرة.
