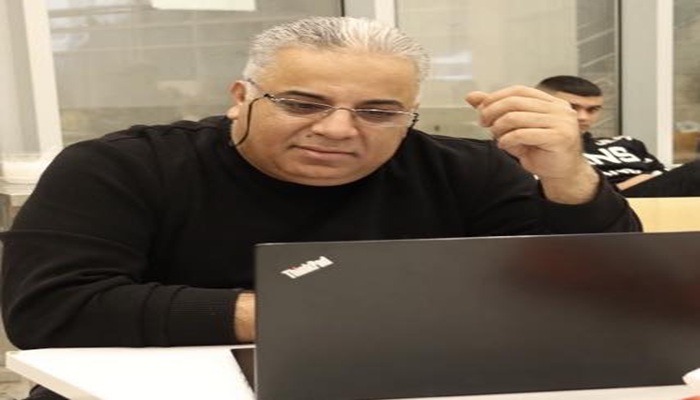
حين يُساء استخدام المفاهيم القانونية في القضايا الكبرى، تصبح اللغة ذاتها خصماً للعدالة، لا أداة لها.
ليس من قبيل الصدفة أن تتردد اليوم مصطلحات مثل "حرب الإبادة" أو أن تُستخَدم مفردة "الإبادة" محل "الإبادة الجماعية" دون إدراك لمعناها القانوني الدقيق. هذا الانزلاق الذي يطال عدداً كبيراً من المفاهيم والمصطلحات "الخاطئة" يمتد إلى أعماق القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، ويبلغ ذروته في أخطر الحقول على الإطلاق: القانون الجنائي الدولي؛ حيث الخطأ في المُفردة يُسقط الملف كاملاً ويُفقد الجريمة الدولية قابليتها للملاحقة.
في مقالنا السابق (عندما يستقيم القانون... تبدأ الثورة من المناهج) أكدنا أن ما يحدث في قطاع غزة ليس "حرباً" ولا "حرب إبادة"، بل هو عدوانٌ شاملٌ وممنهجٌ يقع ضمن إطار نزاع دولي مسلح واحتلال استعماري غير شرعي. ولا يجوز اختزال جرائم دولية، ارتُكبت في هذا السياق، في تعبيرات بلاغية لا وزن لها قانونياً، وتضعف من أدوات المساءلة.
والأخطر أن انتشار "المصطلحات الخاطئة" لا يقتصر على الإعلام، بل تسلل إلى الخطاب الأكاديمي، وتكرَّس اليوم في الفضاء الحقوقي، وتردَّد على ألسنة جهات رسمية تزعم حرصها على العدالة، فيما تغرق كل يوم في وحل اللغة.
بين الإبادة والإبادة الجماعية
الإبادة الجماعية (Genocide) جريمة دولية مستقلة، تُبنى على "القصد الخاص" بإهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها تلك، كلياً أو جزئياً. ويُسميها فقه القانون الجنائي الدولي بجريمة الجرائم (The Crime of Crimes). أمّا الإبادة (Extermination) فهي صورة من صور الجرائم ضد الإنسانية، ولا يُشترط فيها القصد الخاص. والخلط بين الجريمتين ليس زلّة مصطلحية… بل خطأ قاتل يُسقط أهم أركان الجريمة ويفقدها قابليتها للملاحقة القضائية.
العدوان: المفهوم الحاسم
مصطلح العدوان (Aggression) ليس توصيفاً عاطفياً أو خطابياً، بل مصطلح قانوني حاسم، ورد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3314) لسنة 1974، وتبنّاه نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (8 مكرر) تحت عنوان "جريمة العدوان"، والمادة (15 مكرر) بشأن ممارسة اختصاص المحكمة فيما يتعلق بهذه الجريمة، وذلك في التعديلات التي أُقرت في كمبالا بتاريخ 11 حزيران/يونيو 2010.
ورغم أن نظام روما أدخل شروطاً أكثر صرامة لانعقاد الاختصاص فيما يخص جريمة العدوان – لأسباب سياسية وقانونية معقدة – حتى بدت وكأنها نظام خاص داخل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن العدوان يظل التوصيف القانوني الجوهري الذي تُبنى عليه الجرائم الدولية الأخرى، أي جرائم الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، سواء ارتُكبت في قطاع غزة أو في سائر الأرض الفلسطينية المحتلة.
وإن كان البعض يرى أن كلمة "العدوان" لا تُعبّر عن عمق الغضب وحالة الخذلان العالمي والألم الإنساني إزاء ما يجري في غزة، فإنها، مع ذلك، تبقى الأساس القانوني الحاسِم لمسار المساءلة الدولية، بما يشمل المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، وكذلك محكمة العدل الدولية (ICJ) في حالات مسؤولية الدولة، أو انتهاك قواعد القانون الدولي العام، أو مخالفة اتفاقيات دولية مُلزمة. العدوان ليس مجازاً لغوياً… بل مفتاح المساءلة في القانون الدولي.
العدوان على غزة: الأشد دموية في العصر الحديث
يُعدّ العدوان المتواصل على قطاع غزة الأشد فتكًا ودموية في التاريخ الحديث منذ الحرب العالمية الثانية، قياساً بعدد السكان والمساحة، وفق بيانات ومؤشرات الأمم المتحدة.
هذا التوصيف لم يأتِ من فراغ، بل أجمعت عليه تقارير مسؤولي الأمم المتحدة، الذين قلّما يستخدمون هذا المستوى من الوضوح. فقد قال المقرر الخاص المعني بالحق في السكن بالاكريشنان راجاغوبال: "الدمار في غزة أسوأ بكثير مما حدث في حلب وماريوبول، أو حتى دريسدن وروتردام خلال الحرب العالمية الثانية". أمّا نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد فقد وصفت الانهيار القيمي بقولها: "العالم قد فقد بوصلته الأخلاقية تجاه غزة". بينما وصفه مارتن غريفيثس، منسق الشؤون الإنسانية، بـ"خيانة للإنسانية". ورغم ذلك لم يُدرك أحد بعد هول ما جرى ويجري.
ورغم أن هذه التصريحات تشكل لحظة كشف أخلاقي داخل المنظومة الأممية، إلا أن المشكلة الجوهرية لا تتعلق بتوصيف الأمم المتحدة؛ فهي في نهاية المطاف هياكل ضعيفة بلا أدوات تنفيذ ملزمة بمعزل عن إرادة الدول، بل تكمن في فشل الطرف الفلسطيني الرسمي وغير الرسمي في تحويل هذا الزخم الأخلاقي إلى ملفات قانونية حقيقية.
لا تزال الوثائق تتراكم دون بناء سردية جنائية واضحة، ودون توثيق احترافي وفق معايير الأمم المتحدة ومعايير المحكمة الجنائية الدولية، ودون بنك معلومات مصنّف، أو منظومة عمل جماعي صارمة. وهناك خلط مخيف بين الرصد والتوثيق على معايير رصد الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، وبين مجرد "جمع معلومات" عن تلك الجرائم كما يجري في الحالة الفلسطينية، رغم أن "جودة وموثوقية" الدليل حاسِمة في الإثبات الجنائي في مسار المساءلة على الجرائم الدولية عندما يصل الملف إلى مكتب المدعي العام، بتأكيد نص المادة (15) من نظام روما.
من المفردة إلى الملف الجنائي: حين تُبنى العدالة على الدقة
قوة اللغة لا تكمن في المفردة وحدها، بل في ما تُفضي إليه من سردية قانونية دقيقة تُمهّد لمسار المساءلة. هنالك (53) صورة من صور الجرائم الدولية، موصوفة في نظام روما الأساسي، فيما يتصل بالنزاعات المسلحة الدولية والاحتلال الحربي (الاحتلال غير الشرعي في الحالة الفلسطينية) وهي بين جرائم الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. ومع أن غالبية هذه الجرائم الدولية ارتُكبت في غزة بشكل متكرر وممنهج، إلا أنه لا توجد حتى الآن:
• قاعدة بيانات وطنية مهنية
• بنك معلومات وطني مُصنّف
• عمل جماعي موحّد للتوثيق وفق معايير الإثبات الجنائي الدولي
• اهتمام جاد ببناء القدرات في الرصد والتوثيق ومسارات المساءلة
بل إن كثيراً من الجهات الفلسطينية – الرسمية والمنظمات الأهلية – لا تزال تخلط بين التوثيق المهني على معايير الأمم المتحدة ومعايير المحكمة الجنائية الدولية (ICC) وبين مجرد جمع المعلومات، وتغيب عنها أدوات بناء الملف القانوني المتكامل.
الإبادة الجماعية ليست شعاراً!
الإبادة الجماعية ليست تعبيراً عن الغضب، ولا شعاراً انفعالياً، بل جريمة دولية محددة بأركان قانونية صارمة، يتصدّرها "القصد الخاص" (Intent to Destroy)، أي نية إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها تلك، كلياً أو جزئياً. وإن لم يُثبت هذا القصد، مع فشل الأدلة الجنائية، تسقط الدعوى في لاهاي مهما بلغت فظاعة الأفعال أو اتساع رقعتها.
ولهذا، فإن السؤال الجوهري ليس: ما المفردة الأقوى؟ بل: ما الملف الأقوى؟
حتى الآن، لم يطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرات قبض على خلفية جرائم الإبادة الجماعية في الحالة الفلسطينية، رغم الأدلّة الكثيفة والتقارير الأممية. ولم يطلب مذكرات قبض بجرائم التهجير القسري المتكررة التي طالت نحو مليوني إنسان في قطاع غزة وحده، وهي في صدارة الجرائم ضد الإنسانية وارتُكبت بشكل واسع النطاق ومنهجي. ولم يُحرّك "خان" ملف جرائم التعذيب والاحتجاز التعسفي التي طالت أكثر من 15 ألف أسير ومعتقل فلسطيني، ولا جرائم الاختفاء القسري، ولا الفصل العنصري (الأبارتهايد)، ولا جرائم الاستيطان التي هي من الجرائم المستمرة بأركانها وعناصرها وتُرتكب علناً في الأرض الفلسطينية المحتلة.
الأخطر من ذلك أن الجانب الفلسطيني، الرسمي وغير الرسمي، لا يزال عاجزاً عن تقديم إحالات متخصصة مكثفة ومنظمة ومتكاملة تطال الجرائم (53 جريمة دولية) المنصوص عليها في نظام المحكمة الجنائية الدولية مع الدلائل القوية على ارتكاب معظمها. فلا ملفات جاهزة، ولا بنية تنسيق، ولا عمل جماعي محترف. الإبادة الجماعية لا تُثبت بالغضب، بل بالأدلة. وإذا لم تواكب السردية البلاغية سرديةٌ جنائية موثقة… ستبقى العدالة خارج قاعة المحكمة.
تجليات الانهيار: الأخطاء الطبية المتعمدة!
من أكثر صور الانهيار المفاهيمي إيلاماً في الخطاب الفلسطيني ما نسمعه مراراً عن "الأخطاء الطبية المتعمدة" التي تُرتكب بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي.
هذا التعبير المتناقض المتداول في الإعلام والبيانات الرسمية، والأهلية، والأوساط أكاديمية، يُقوّض أبسط قواعد التوصيف القانوني؛ إذ لا يُعقل، منطقاً ولا قانوناً، أن يكون الفعل "خطاً" و"متعمداً" في آنٍ واحد! والخطأ ينفي أساساً وقوع الجريمة الدولية!
في القانون الجنائي الدولي، لا تُبنى الجريمة الدولية على الخطأ، بل على العمد، أو الجسامة، أو التكرار المنهجي كنهج وسياسة دولة. وما نشهده من حرمان للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من العلاج، أو تأخيره عمداً، أو تقديمه بصورة تؤدي إلى الوفاة أو الإعاقة، لا يندرج ضمن "أخطاء طبية" لأن الخطأ يندرج ضمن الجرائم غير المقصودة ويظهر في صورة الإهمال أو قلة الاحتراز أو مخالفة البروتوكولات الطبية على نحو غير مُتعمد، بل يصل وبشكل واضح إلى "جرائم طبية متعمدة" تُشكّل أحد أنماط التعذيب أو سوء المعاملة أو حتى القتل العمد في التوصيف القانوني.
استخدام مصطلح "الجرائم الطبية المتعمدة" بدلاً من فوضى مصطلح "الأخطاء الطبية المتعمدة" ليس تحسيناً بلاغياً، بل إنقاذاً لملف قانوني يُمكن أن يُقدَّم للمحكمة الجنائية الدولية. أمّا الإبقاء على هذا التوصيف المرتبك، فهو يُقوّض إثبات الركن المعنوي للجريمة، ويمنح الجناة هامش الإنكار والإفلات من العقاب على ارتكاب جرائم دولية!
التطهير العرقي: الخلط بين الوصف والجريمة!
يُشير مصطلح "التطهير العرقي" إلى السياسات والممارسات التي تهدف إلى إزالة أو طرد مجموعة إثنية أو عرقية معينة من منطقة جغرافية محددة باستخدام وسائل قسرية، تشمل التهجير، التهديد، أو القتل. وقد شاع استخدامه خلال النزاعات في يوغوسلافيا السابقة في تسعينيات القرن الماضي، لوصف الجرائم المرتكبة ضد جماعات إثنية، وانتقل لاحقاً إلى الخطاب الفلسطيني، لا سيما من خلال المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه، الذي وثّق في كتابه "التطهير العرقي في فلسطين" (The Ethnic Cleansing of Palestine) عمليات التهجير القسري للفلسطينيين عام 1948 واصفاً إياها بأنها تطهير عرقي ممنهج.
لكن الإشكال الجوهري لا يكمن في مشروعية استخدام المصطلح سياسياً أو تاريخياً، بل في سوء استخدامه قانونياً. فـ"التطهير العرقي “رغم انتشاره في الخطاب السياسي والحقوقي والإعلامي والأكاديمي، ليس جريمة معترفاً بها كجريمة مستقلة في القانون الجنائي الدولي. النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهو المرجع الحاكم لمسار المساءلة الجنائية، لا يتضمن أي نص يُجرّم "التطهير العرقي" كجريمة قائمة بذاتها.
بمعنى آخر، وأوضح، لا يمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (كريم خان) أن يطلب من الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية توجيه تهمة بجريمة "تطهير عرقي" لأي متهم، لأن هذا الوصف لا وجود له في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأكمله (128 مادة) نصاً أو دلالة أو توصيفاً جُرمِياً مستقلاً.
إيلان بابيه "مؤرخ"، لا مشرّع ولا قاضٍ في مجال القانون الجنائي الدولي. كما أن استخدام مصطلح "التطهير العرقي" في تقارير بعض المقررين الخاصين أو في أدبيات الأمم المتحدة لا يُغيّر من هذه الحقيقة، لأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يقوم على مبدأ الشرعية الجنائية (Principle of Legality in International Criminal Law) الذي يُعدّ حجر الأساس في القانون الجنائي الدولي، ويقضي بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وأنه لا يجوز محاكمة أي فعل لم يكن مُجرَّماً بشكل صريح وواضح وقت ارتكابه، أي منصوص عليه بنص صريح في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
لذلك، حتى لو كان مصطلح "التطهير العرقي" يُرضي بعض الحاجات التعبيرية في الخطاب السياسي أو الإعلامي أو الأكاديمي، فإن إدراجه في ملف قانوني مُقدَّم إلى المحكمة الجنائية الدولية يُربك البناء القانوني، ويُدخل القضية في مساحات رمادية تُهدّد مسار المساءلة، وتُضعف التوصيف الجنائي للجريمة الدولية وفق مبدأ الشرعية الجنائية، وتمنح المتهمين فرصاً إضافية للإفلات من العقاب. إنه مصطلح خارج إطار القانون الجنائي الدولي، قد يجد مكانه في الأدبيات السياسية أو تقارير المقررين الخاصين، لكنه لا يصلح مرجعية قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وهنا يأتي دور السردية القانونية المُنظمة: بإمكاننا إعادة قراءة أفعال التطهير العرقي من منظور الجرائم المعترف بها، مثل: التهجير القسري (المادة 1/7/د) كجريمة ضد الإنسانية، أو الاضطهاد، أو حتى الإبادة الجماعية إذا ثبت القصد الخاص بإهلاك جماعة قومية أو إثنية أو دينية بصفتها تلك. تمهيداً لتكييفها في المسارات الجنائية الممكنة.
وفي جميع الأحوال، لا شيء يمنع دولة فلسطين، بصفتها عضواً في جمعية الدول الأطراف في المحكمة، من التقدّم بمقترح إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) وإضافة "التطهير العرقي" كجريمة دولية مستقلة ضمن الجرائم الدولية الموصوفة فيه، وذلك وفقاً للقواعد الإجرائية المنصوص عليها في المادتين (121) و(122) من نظام المحكمة الجنائية. وليكن ذلك اختباراً للدبلوماسية الفلسطينية العجوز!
فالمعركة ليست على الكلمة الأكثر بلاغة، بل على الوصف الأشدّ واقعاً أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، ولاحقاً أمام قضاتها في قاعة المحكمة. وإذا لم تواكب السردية البلاغية سرديةٌ جنائية موثقة ومدعّمة بالأدلة الموثوقة، ستبقى العدالة في مكان، والخطاب في مكان آخر.
فما نُسميه خارج المحكمة الجنائية الدولية، لا يعني شيئاً؛ إن لم يكن قابلاً للملاحقة الجنائية داخلها.
هذه ليست أزمة مفردات... بل أزمة سردية
العدالة لا تبدأ بالشعارات. والإبادة الجماعية ليست صرخة وجدانية، بل جريمة دولية ذات أركان صارمة. والغضب، مهما كان صادقاً، لا يُغني عن بناء ملفات قانونية تُغرق المحكمة الجنائية الدولية بأدلّة راسخة لا تُرَد.
لهذا كلّه…
فإن تأسيس مختبر قانوني للمفاهيم والمصطلحات ليس ترفاً بحثياً، ولا شأناً نخبوياً، بل ضرورة وطنية ومَهمّة وجودية. مختبرٌ يُعيد امتلاك اللغة، ويُحرّر المصطلحات من التشويش، ويصوغ الرواية الفلسطينية بلغة القانون، ليصنع من أدواته سيفاً للعدالة، لا نشيداً حزيناً.
مَن لا يملك لغته القانونية... لا يستطيع أن يُرافع باسم دمه.
إنها دعوة للنقاش، ونداء للعقل، وصوتٌ من الضمير… لنبدأ.
